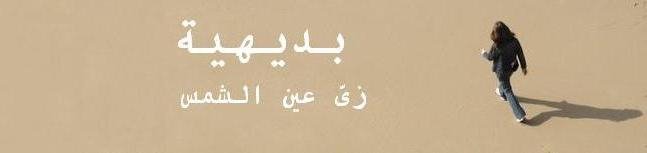الإنتظار فى المكان الخطأ:
كنا فى انتظار السيد المناضل "جودو"، مُحرر ميدان التحرير من الأمن المركزي، ومُحرر الأرض الفلسطينية من الصهاينة، تمر الدقائق ونحن نتبادل النظرات بيننا، تنتصف الشمس فى صفحة السماء، وضباط المباحث يقفون بعيداً وبسمات السخرية المقيتة ترتسم فوق وجوههم، كيف يخشى كيان الدولة الهائل بضعة بلهاء حالمين متناثرين ؟، يلتف المخبرون حولنا فى دائرة مغلقة، أخيراً صدرت الأوامر بالاعتقال بتهمة "الحماقة الرومانسية".. والسيد "جودو" خذلنا ولم يأتِ بعد.
"أول مطلب فى الليمان.. تورتة حلوة لست إيمان"
"أول مطلب للمساجين.. تورتة حلوة لكل سجين"
الأشياء تستعيد مذاقها الأصلي، البهجة وضحكاتها، السخرية ومرارتها، الحماس واشتعاله، حتى القلق مذاقه في ساعات الإحتجاز اختلف، والمخبرون بوجوههم التى تصطنع اللامبالاة يتمايزون غيظاً وكيداً عاجزين عن فهمنا.
تواشيح وأناشيد ومواويل بتتغنى، هقهقة ومقالب وضحك بيجلجل، سقف العنابر يتشقق، وأبص من ورا القضبان والشقوق ألمح شجر متجمع، شجر مكوّن فرقة تخت شرقى، قانون وعود ورقّ وناي، وبيعزف ألحانه الهادية طول الليل طول الليل، بعدها ألمح مصانع الأسمنت بتشغى غبار، يغطى كل شئ حتى الشجر اللى أوراقه بقت زى ورق مفضض بيلمع تحت القمرة، بعدها صحارى وقنا ضيقة وتلال وجبال فاضية ولا فيها صريخ ابن يومين، بعدها غزة على قبة البركان مستنية تفيض على الأرض هناك لحد هنا.
كنا فى انتظار السيد المناضل "جودو"، مُحرر ميدان التحرير من الأمن المركزي، ومُحرر الأرض الفلسطينية من الصهاينة، تمر الدقائق ونحن نتبادل النظرات بيننا، تنتصف الشمس فى صفحة السماء، وضباط المباحث يقفون بعيداً وبسمات السخرية المقيتة ترتسم فوق وجوههم، كيف يخشى كيان الدولة الهائل بضعة بلهاء حالمين متناثرين ؟، يلتف المخبرون حولنا فى دائرة مغلقة، أخيراً صدرت الأوامر بالاعتقال بتهمة "الحماقة الرومانسية".. والسيد "جودو" خذلنا ولم يأتِ بعد.
*
فى عربة الترحيلات، دسست أصابعي فى فتحات النافذة، ونفثت دخان السيجارة إلى خارج العربة فى الهواء متأملاً حريته، حاولت إدراك شعور المحتجز السجين لكننى فشلت، فالعالم الخارجي يبدو شاسعاً بلا معنى، قاحل وجاف ومقفر، كنا هنا نتوهج بالهتاف، نتوهج بالنكات، نتوهج بالغناء، وبالأشعار والرقصات، الحماس الحىّ، وإن سكن قليلاً، لا يهمد أبداً، تارة نطلب مشروبات وهمية، زميل يطلب قهوة بالليمون، كأن الحياة ليس بها ما يكفى من المرارة اللاذعة، وتارة أخرى نغنى إحتفالاً بعيد ميلاد زميلة أخرى ونهتف قائلين:"أول مطلب فى الليمان.. تورتة حلوة لست إيمان"
"أول مطلب للمساجين.. تورتة حلوة لكل سجين"
الأشياء تستعيد مذاقها الأصلي، البهجة وضحكاتها، السخرية ومرارتها، الحماس واشتعاله، حتى القلق مذاقه في ساعات الإحتجاز اختلف، والمخبرون بوجوههم التى تصطنع اللامبالاة يتمايزون غيظاً وكيداً عاجزين عن فهمنا.
*
غ.ز.ة:تواشيح وأناشيد ومواويل بتتغنى، هقهقة ومقالب وضحك بيجلجل، سقف العنابر يتشقق، وأبص من ورا القضبان والشقوق ألمح شجر متجمع، شجر مكوّن فرقة تخت شرقى، قانون وعود ورقّ وناي، وبيعزف ألحانه الهادية طول الليل طول الليل، بعدها ألمح مصانع الأسمنت بتشغى غبار، يغطى كل شئ حتى الشجر اللى أوراقه بقت زى ورق مفضض بيلمع تحت القمرة، بعدها صحارى وقنا ضيقة وتلال وجبال فاضية ولا فيها صريخ ابن يومين، بعدها غزة على قبة البركان مستنية تفيض على الأرض هناك لحد هنا.